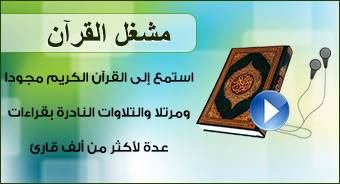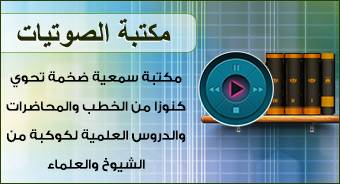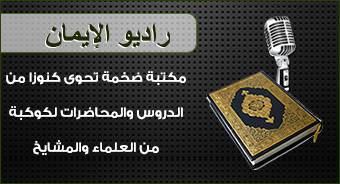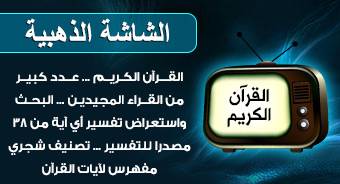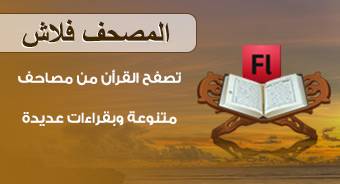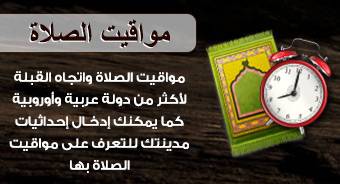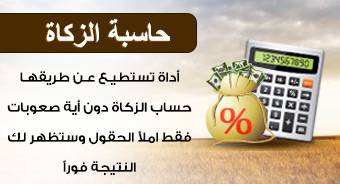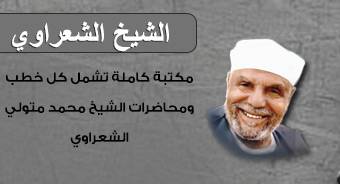.النوع الرابع عشر: المعرفة بأيام الحروب الواقعة:
.النوع الرابع عشر: المعرفة بأيام الحروب الواقعة:
وفيه ثلاثة مقاصد:المقصد الأول في وجه احتياج الكاتب إلى ذلك:قد ذكر في حسن التوسل: أن الكاتب يحتاج إلى معرفة أيام العرب، وتسميته الأيام التي كانت بينهم، ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرى، وما جرى بينهم من الأشعار، والمناقضات، وذكر فارس مشهور، أو ملك مذكور، أو واقعة معينة لشخص خاص، وما ادعاه كل منهم لنفسه أو ليومه: لما في ذلك من العلم بما يستشهد به من واقعة قديمة، أو يرد عليه في مكاتبة من ذكر يوم مشهور، أو فارس معين، ونحو ذلك مما مضى عليه أمر الجاهلية، أو حدث في الإسلام؛ فإن الكاتب إذا لم يمكن عارفاً بالوقائع، عالماً بما جرى منها، لم يدر كيف يجيب عما يرد عليه من مثلها، ولا ما يقول إذا سئل عنها.المقصد الثاني في ذكر أيام من ذلك ترشد إلى معرفة المقصد منه:ومن أشهر ذكراً، وأعظمها حرباً: يوم خزاز، خزاز اسم جبل بين البصرة ومكة كانت الواقعة عنده فعرفت به؛ وكانت الحرب فيه بين بني ربيعة الفرس، وهو ربيعة نزار، وبين قبائل اليمن؛ وكانت الغلبة فيه لبني ربيعة، فقتلوا من قبائل اليمن خلقاً كثيراً، وكان قائد ربيعة كليب بن ربيعة ملك بني وائل واسمه وائل وكليب لقب عليه وهو من ربيعة الفرس، وكان قد ملك على بني معد وقبائل جموع العرب وهزمهم وعظم شأنه، وبقي زماناً من الدهر، ثم داخله زهو شديد، وبغى على قومه فصار يحمي عليهم مواقع السحاب، ولا يرعى حماه، ويقول: وحش أرض كذا في جواري، فلا يصاد؛ ولا ترد إبل مع إبله، ولا توقد نار مع ناره؛ وبقي كذلك حتى قتله جساس بن مرة الوائلي أيضاً؛ ولما قتل كليب توالت الحروب بسبب قتله بين بني تغلب، وبين بكر ابني وائل؛ وكان قائد بني تغلب مهلهل أخو كليب، وقائد بني بكر مرة أبو جساس المقدم ذكره؛ فكان بينهم يوم عنيزة، وتكافأ فيه الفريقان، ثم كان بينهم يوم واردات، وانتصر فيه بنو تغلب على بكر، ثم كان بينهم يوم الحنو، وانتصرت فيه بكر على تغلب، ثم كان بينهم يوم العصيات، وانتصرت فيه تغلب على بكر، وأصيب بنو بكر حتى ظنوا أنهم قد بادوا، ثم كان بينهم يوم قضة، وهو يوم التحالق كثر فيه القتل لين الفريقين، في أيام أخر لم يشتد فيها القتال.ومن أيام غيرهم المشهورة يوم عين أباغ. وعين أباغ موضع يقال له ذات الخيار؛ وكان الحرب فيه بين غسان ولخم، وكان قائد غسان الحارث الذي طلب أدرع امرئ القيس، وقيل غيره، وكان قائد لخم المنذر بن ماء السماء بغير خلاف؛ وفي هذا اليوم قتل المنذر وانهزمت لخم، وتبعتهم غسان إلى الحيرة وأكثروا فيهم القتل. ويوم مرج حليمة، وكان بين غسان ولخم أيضاً؛ وكان من أعظم الأيام وأشدها حرباً، بلغت الجيوش فيه عدداً كثيراً، وعظم الغبار حتى قيل إن الشمس احتجبت وظهرت الكواكب التي في غير جهة الغبار. ويوم الكديد، وكان بين كنانة وسليم، وانتصرت فيه سليم على كنانة، وقتل فيه ربيعة بن مكدم فارس كنانة؛ وبه يضرب المثل في الشجاعة؛ وكان يعقر على قبره في الجاهلية، ولم يعقر على قبر غيره. ويوم الكلاب الأول؛ والكلاب موضع بين البصرة والكوفة؛ وكان بين الأخوين: شراحيل وسلمة ابني الحارث بن عمرو الكندي؛ وشراحيل هو الأكبر وكان معه بكر وائل وغيرهم، وسلمة الأصغر، وكان معه تغلب وائل وغيرهم، واشتد القتال بينهم، وانتصر سلمة وتغلب على شراحيل وبكر، وانهزم شراحيل وتبعته خيل أخيه فقتلوه. ويوم الكلاب الثاني، وكان بين بكر ووائل. ويوم أوارة، وأوارة اسم جبل وكانت الحرب فيه بين المنذر ابن امرئ القيس ملك الحيرة، وبين منذر وائل بسبب الحيرة، وظفر فيه المنذر، وأقسم أنه لا يزال يذبحهم حتى يسيل دمهم من رأس أوارة إلى حضيضه، وبقي يذبحهم والدم يجمد فسكب عليه ماء حتى سال الدم من رأس الجبل إلى حضيضة، وبرت يمينه. ويوم رحرحان، ورحرحان اسم واد بالحجاز وكانت الحرب فيه بين الأحوص بن جعفر بن كلاب، وبني دارم، وبني ماوية، وبني معبد بن زرارة، وبني تميم؛ وانهزمت فيه بنو تميم ومن معهم، وأسر معبد بن زرارة؛ وقصد أخوه لقيط بن زرارة أن يستفكه فلم يقدر، وعذبوا معبداً حتى مات. ويوم شعب جبلة، وشعب جبلة هضبة حمراء بين الشريف والشرف. وكان من شأنه أنه لما انقضت وقعة رحرحان المتقدمة، ومضى لها سنة، وذاك في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنجد لقيط بن زرارة التميمي بني ذبيان لثأر أخيه فأنجدته، وتجمعت بنو تميم غير بني سعد، وخرجت معه بنو أسد، وسار بهم لقيط إلى بني عامر وبني عبي في طلب ثأر أخيه معبد، فأدخلت بنو عامر وبنو عبس أموالهم في شعب جبلة، فحضرهم لقيط فخرجوا عليه من الشعب وكسروا جمائع لقيط وقتلوا لقيطاً، وأسروا أخاه حاجب بن زرارة، وانتصرت بنو عامر وبنو عبس نصراً عظيماً؛ وقتل أيضاً من بني ذبيان وبني تميم ومن بني أسد جمعة مستكثرة؛ وكان هذا اليوم من أعظم أيامهم. ويوم ذي قار، وهو أقرب الوقائع المشهورة في الجاهلية عهدا، وكان في سنة أربعين من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقيل عام بدر.وكان من حديثه أن كسرى أبرويز غضب على النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فحبسه فهلك في الحبس؛ وكان النعمان قد أودع حلقته وهي السلاح والدروع عند هانيء بن مسعود البكري، فأرسل أبرويز يطلبها من هانئ، فقال هذه أمانة، والحر لا يسلم أمانته؛ وكان أبرويز لما أمسك النعمان جعل مكانه في ملك الحيرة إياس بن قبيصة الطائي؛ فاستشار أبرويز أيأساً، فقال إياس: المصلحة التغافل عن هانيء بن مسعود حتى يطمئن ونتبعه فندركه، فقال أبرويز: إنه من أخوالك لا تألوه نصحاً، فقال إياس: رأي الملك أفضل؛ فبعث أبرويز الهزبران في ألفيبن من الأعاجم، وبعث ألفاً من بهراء، فلما بلغ بكر بن وائل خبرهم أتوا مكاناً من بطن ذي قار، فنزلوه ووصلت إليهم الأعاجم، واقتتلوا ساعة فانهزمت الأعاجم هزيمة قبيحة؛ فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم، خبر بذلك أصحابه، فقال: اليوم أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا.ولأبي عبيدة مصنف مفرد في أيام العرب، وقد أورد منها ابن عبد ربه في كتاب العقد جملة مستكثرة، وفي آخر كتاب الأمثال للميداني نبذة محررة من ذلك، وليس بنا حاجة إلى استيعابها هنا.وأما الحروب الواقعة في صدر الإسلام، فمنها وقعة الجمل، وكانت بين علي كرم الله وجهه، ومعه أهل الكوفة، وبين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت راكبة يومئذ على جمل اسمه عسكر وبه عرفت الوقعة، وقتل بين الفريقين خلق كثير، وكانت النصرة فيه لعلي ومن معه.ومنها وقعة صفين، وكانت بين عي كرم الله وجهه ومعه أهل العراق، وبين معاوية بن أبي سفيان، ومعه أهل الشام، وكان ابتداؤها في سنة ست وثلاثين، وكان مندة مقامهم بصفين مائة وعشرة أيام أوقعوا فيها وقعات كثيرة؛ قيل تسعين وقعة؛ وكانت عدة القتلى بينهم فيما يقال من أهل الشام خمسة وأربعين ألفاً، ومن أهل العراق ستة وعشرين ألفاً، منهم ستة وعشرون من أهل بدر؛ وكان عمار بن ياسر مع علي رضي الله عنه، وقاتل حتى قتل، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
«يقتل عماراً الفئة الباغية» ومضت عليهما مدة، وعلي رضي الله عنه على العراق، ومعاوية على الشام ومصر، إلى أن قتل علي رضي الله عنه.ولا حاجة بنا إلى الخوض في أكثر من ذلك، فإن ذلك محمول على اجتهادهم، والإمساك عما شجر بينهم واجب.ومنها وقعة مرج راهط؛ وكان من حديثها أنه لما هلك يزيد ين معاوية، كان سعيد بن بحدل على قنسرين، فوثب عليه زفر بن الحارث فأخرجه منها وبايع عبد الله بن الزبير، فلما قعد زفر على المنبر، قال: الحمد لله الذي أقعدني مقعد الغادر الفاجر، وحصر، فضحك الناس من قوله؛ وكان حسان بن بحدل على فلسطين، والأردن، فوثب ناتل بن قيس الجذامي على روح ابن زنباع فأخرجه من فلسطين وبايع ابن الزبير؛ وكان النعمان بن بشير على حمص فبايع لابن الزبير، وكان الضحاك بن قيس على دمشق، فجعل يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، فقدم عليه مروان بن الحكم فقال الضحاك هل لك أن تقدم على ابن الزبير ببيعة أهل الشام، قال نعم ووافق على ذلك بنو أمية، واليمانيون؛ فلما فشا ذلك أرسل الضحاك إلى بني أمية تصدر إليهم؛ وقال لمروان وعمرو بن سعيد: اكتبوا إلى حسان بن بحدل فيسير من الأردن حتى ينزل الجابية، ونسير نحن من هنا حتى نلقاه فننظر هناك رجلاً ترضونه؛ فلما استقلت رايات الضحاك من دمشق، قالت القيسية لا نصحبك دعوتنا إلى بيعة ابن الزبير، وهو رجل هذه الأمة، فلما بايعناك خرجت تابعاً لهذه الأعراب بني كلب، فأجابهم إلى إظهار بيعة ابن الزبير، وسار حتى نزل مرج راهط، وأقبل حسان حتى لقي مروان، فسار مع مروان حتى لقوا الضحاك، وهم نحو من سبعة آلاف، والضحاك في نحو ثلاثين ألفاً، واقتتلوا، فقتل الضحاك وقتل معه أشراف من قريش.المقصد الثالث في كيفة استعمال الكات ذكر هذه الوقائع في كلامه:لا يخفى أن الكاتب المترشح للكتابة إذا كان من المعرفة بأيام الحرب، والعلم بتفاصيل أخبارها، ون يعد من فرسان حروبها، ومصاقع خطبائها، ومفلقي شعرائها، وما جرى بينهم في ذلك من الخطب والأشعار والمناقضات، كان مستعداً لما يستشهد به من واقعة قديمة، وأو يريد عليه في مكاتبة، أو شعر: من ذكر أيام مشهورة، أو ذكر فارس معين؛ كما قال أبو تمام الطائي يمدح بني شيبان:
إذا افتخرت يوماً تميم بقوسها ** وزادت على ما وطدت من مناقبفأنتم بذي قار أمالت سيوفكم ** عروش الذين استرهنوا قوس حاجبيشير إلى أن حاجب بن زرارة التميمي وفد على كسرى في سنة جدب، فقال الحاجب من أنت؟ قال رجل من العرب، فلما دخل على كسرى قال له من أنت؟ قال سيد العرب؛ قال ألم تقل بالباب إنك رجل من العرب؟ قال كنت بالباب رجلاً منهم فلما حضرت بين يدي الملك سدتهم؛ فملأ فمه دراً، وشكا إليه محل الحجاز، وطلب منه حمل ألف بعير براً، على أن يعيد قيمتها، فقال وما تراهنني على ذلك؟ قال قوسي، فاستعظم همته وقال قبلت، وأعطاه حمل ألف بعير براً، ومات حاجب فأحضر بنوه المال بعد موته وطلبوا من قوس أبيهم فافتخرت تميم بذلك. فأشار أبو تمام في بيته إلى هذه المنقبة، يقول: يا بني شيبان في يوم ذي قار أبدتم جيوش كسرى الذي استرهن قوس حاجب.وكما قال أبو نصر الفتح بن خاقان، في خطبة كتابه قلائد العقيان: لو جاوره كليب ما طرق حماه، أو استجار به أحد من الدهر حماه، أو كان بوادي الأخرم، لطاف به ربيعة وأحرم، أو استنجده الكندي ما كساه الملاءة، أو كان حاضراً بسطام لما خر على الآلاءة.وكما قلت في المفاخرة بين السيف والقلم عند التعرض لذكر المقر الزيني أبي يزيد الدودار الذي من أجله وضعت فلو لقيه فارس عبس لولى عابساً. أو طرق حمى كليب لبات من حماه آيسأ، أو قارعه ربيعة بن مكدم لعلاع بالسيف مفرقه، أو نازله بسطام لبدد جمعه وفرقه.إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى وانتظم في هذا السلك.قال في حسن التوسل: وإذا لم يكن صاحب هذا الفن عارفاً بكل يوم من هذه الأيام، عالماً بما جرى فيها، لم يدر كيف يجيب عما يرد عليه من مثلها، ولا ما يقول إذا سئل عنها. قال: وحسبه ذلك نقصاً في صناعته، وقصوراً عما يتعين عليه من معرفته وحسن الجواب عنه عند السؤال عنه.وأما الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام فقد قال الوزير ضياء الدين بن الأثير رمه الله في المثل السائر: إنها كالأمثال في الاستشهاد بها وذكر لها أمثلة، منها قوله من كتاب: ولا يعد البر براً حتى يلحق الغيب بالحضور، ويصل من لم يصله بجزاء ولا شكور؛ فزنة الغائب بالشاهد من رم الإحسان، ولهذا نابت شمال رسول الله عن يمين عثمان. يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، في بيعة الحديبة كان قد أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة في حاجة، ولم يحضر البيعة، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيده الشمال على اليمين وقال:
«هذه عن عثمان وشمالي خير من يمينه».يشير بذلك إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استدعى أبا موسى الأشعري ومن يليه من العمال وكان منهم الربيع بن زياد الحارثي، فذهب الربيع بن زياد إلى بعض موالي عمر وسأله عما يروج عنده ونيفق عليه، فأشار إلى خشونة العيش فمضى، وليس جبة صوف، وعمامة رثاء، وخفا مطابقاً، وحضر بين يديه في جملة العمال، فصوب عمر نظره وصعده فلم يقع إلا عليه، فأدناه وسأله عن حاله، ثم أوصى أبا موسى الأشعري به.ومنها قوله في معارضة كتاب القاضي الفاضل إلى ديوان الخلافة يعدد فيه مساعي الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وما قاساه في الفتوح من الأهوال وهو: ومن جملتها ما فعل الخادم في الدولة المصرية، وقد قام بها منبر وسرير، وقالت منا أمير ومنكم أمير، فرد الدعوة العباسية إلى معادها، وأذكر المنابر ما نسيته بها من زهو أعوادها. يشير بذلك إلى ما تقدم من اجتماع الأنصار في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، في سقيفة بني ساعدة الة سعد بن عبادة، وكيف ذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وقال الحباب بن المنذر: منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء. إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى وينتظم في هذا السلك:
 .النوع الخامس عشر في أوابد العرب:
.النوع الخامس عشر في أوابد العرب:
وهي أمور كانت العرب عليها في الجاهلية، بعضها يجري مجرى الديانات، وبعضها يجري مجرى الاصطلاحات والعادات، وبعضها يجري مجرى الخرافات، وجاء الإسلام بإبطالها، وهي عدة أمور:منها الكهانة، وكان موضوعها عندهم الإخبار عن أمور غيبية بواسطة استراق الشياطين السمع من السماء، وإلقاء ما يستمعونه من الغيبات إليهم. وقد كان في العرب قبل البعثة عدة كهنة تعتمد العرب كلامهم، ويرجعون إلى حكمهم فيما يخبرون به.ومن عجيب أخبارهم في ذلك أن هند ابنة عتبة بن ربيعة كانت تحت الفاكه بن المغيرة المنخزومي، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن، فخلا تالبيت يوماً فاضطجع الفاكه هو وهند فيه، ثم نهض الفاكه لبعض حاجته، وأقبل رجل ممن كان يغشى البيت فولجه فلما رآها ولى هارباً وأبصره الفاكه فأقبل إلى هند فركضها برجله وهي نائمة فانتبهت. فقال من ذا الذي خرج من عندك، فقالت لم أر أحداً وأنت الذي أنبهتني، فقال لها اذهبي إلى بيت أبيك فأقيمي عنده! وتكلم الناس فيها، فقال له أبوها إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم، فحاكمني إلى بعض كهان اليمن، فخرجا في جماعة من قومهما إلى كاهن من كهان اليمن ومعهما هند ونسوة أخر، فلما شارفوا بلاد الكاهن، قالت هند لأبيها: إنكم تأتون بشراً يصيب ويخطئ ولا آمنه أن يسمني ميسماً يكون علي سبة، فقال أبوها سأختبره لك فصفر لفرسه حتى أدلى، فأدخل في إحليله حبة حنطة وشد عليها بسير، فلما دخلوا على الكاهن، قال له عتبة: إنا قد جئناك في أمر وقد خبأت لك خبأ أختبرك به فانظر ما هو فقال ثمرة في كمرة، فقال أريد أبين من هذا، فقال حبة بر، في إحليل مهر، فقال له انظر في أمر هؤلاء النسوة، فجعل يدنو من إحداهن فيضرب بيده على كتفها ويقول انهضي حتى دنا من هند فقال لها: انهضي غير رسحاء ولا زانية ولتلدن ملكاً اسمه معاوية؛ فنهض إليها الفاكه فأخذ بيدها، فجذبت يدها من يده. وقالت إليك عني! فوالله لأحرص على أن يكون من غيرك، فتزوجها أبو سفيان ابن حرب فولدت له معاوية؛ فكان من أمره ما كان إلى أن انتهت به الحال إلى الخلافة. وقد أخبر جماعة من الكهنة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قرب ظهوره منهم سطيح الكاهن وغيره.ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حرست السماء ومنعت الشياطين من استراق السمع كما أخبر تعالى بقوله:
{وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا}.ومنها الزجر والطيرة: وهما في معنى واحد؛ وأصله أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أمر أو تركه زجروا الطير حتى يطير؛ فإن طار يميناً كان له حكم، وإن طار شمالاً كان له حكم، وإن طار إماماً كان له حكم، وإن طار من فوق رأسه كان له حكم، ومن ثم سميت الطيرة أخذاً من اسم الطير، وأكثر ما عولوا عليه من ذلك الغراب، ثم تعدوه إلى غير الطير من الحيوان، ثم جاوزا ذلك إلى ما يحدث في الجمادات من كسر أو صدع أو نحو ذلك؛ وربما انتهى بعض الزجر إلى حد الكهانة.ومما يحكى من زجر الطير أن رجلاً من لهب: وهم بطن من العرب يعرفون بالعيافة، خرج في حاجة له، ومعه سقاء من لبن فسار صدر يومه فعطش فأناخ ليشرب فإذا غراب فنعب فأثار راحلته، ثم سار حتى كان وقت الظهيرة أناخ ليشرب، فنعب الغراب وتمرغ في التراب، فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه ثعبان عظيم فقتله. ثم سار فإذا غراب واقع على سدرة فصاح به فوقع على سلمة، فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليها،، فأثار من تحتها كنزاً، فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت؟ قال سرت صدر يومي فأنخت أشرب فنعب الغراب، فقال: أثر راحلتك وإلا فلست بابني، قال فعلت، قال ثم ماذا؟ قال سرت حتى وقت الظهيرة فأنخت لأشرب فنعب الغراب، وتمرغ في التراب، فقال اضرب السقاء وإلا فلست بابني. قال فعلت، فوقع على صخرة قال أثر ما تحتها وإلا فلست بابني، قال فعلت، فوجدت كنزاً.وقد وردت السنة بإبطال حكم الزجر والطيرة بقوله صلى الله عليه وسلم:
«أقروا الطير في وكناتها» وقوله صلى الله عليه وسلم:
«ولا عدوى ولا طيرة» واستحسن صلى الله عليه وسلم، الفأل فقال:
«ويعجبني الفأل وهي الكلمة الطيبة أسمعها». وقد فرق العلماء بين الفأل والطيرة، بأن الطيرة تقصد والفأل يأتي من غير قصد.ومنها الميسر: وهو ضرب من القمار كانوا يقتسمون به لحم الجزر التي يذبونها بحسب قداح يربونها، لكل قدح منها نصيب معلوم، وهي أحد عشر قدحاً: سبعة منها لها حظ إن فازت وعليها غرم إن خابت بقدر مالها من الحظ عند الفوز، وأربعة منها تثقل بها القداح لا حظ لها إن فازت، ولا غرم عليها إن خابت. فأما السبعة التي لها الحظ إن فازت وعليها الغرم إن خابت، فأولها الفذ: وهو قدح في صدره حز واحد، وله نصيب واحد في الأخذ والغرم. والثاني التوأم، وفي صدره حزان، وله نصيبان في الأخذ والغرم. والثالث الضريب ويسمى الرقيب وفيه ثلاثة حزوز، وله ثلاثة أنصباء. والرابع الحلس وفيه أربعة حزوز وله أربعة أنصباء. والخامس النافس وفيه خمسة حزوز، وله خمسة أنصباء. والسادس المسبل، ويسمى المصفح أيضاً، وفيه ستة حزوز وله ستة أنصباء. والسابع المعلى، وفيه سبعة حزوز، وله سبعة أنصباء، وهو أوفرها حظاً، ولذلك يضرب به المثل في الحظ فيقال قدحه المعلى.وأما الأربعة التي تثقل بها القداح فهي السفيح، والمنيح، والمضعف والوغد، وكان طريقهم في ذلك أن القوم يجتمعون فيشترون جزوراً فينحرونها ويفصلونها على عشرة أجزاء، ويستهمون فيها على سبعة أنصباء لا أكثر، وتسمى الأنصباء فيها الأيسار، فإن كانوا أقل من سبعة وأراد أحدهم قدحين أو أكثر، أخذ وكان له فوزها، وعليه غرمها؛ فإذا جزؤا الجزور على ذلك، أتوا برجل يسمونه الحرضة، من شأنه أنه لم يأكل لحماً قط بثمن، ويؤتى بالقداح فتشد مجموعة في قطعة جلد تسمى الربابة، ثم يلف الحرضة على يده اليمنى ثوباً، لئلا يجد مس قدح له مع صاحبه هوى فيحابيه في إخراجه، ثم يؤتى بثوب أبيض يسمى المجول، فيبسط بين يدي الحرضة، ويقوم على رأسه رجل يسمى الرقيب، ويدفع ربابة القداح إلى الحرضة، وهو محول الوجه عنها، فيأخذ الربابة التي تجمع فيها القداح إلى الحرضة، وهو محول الوجه عنها، فيأخذ الربابة التي تجمع فيها القداح، ويدخل يده تحت الثوب فينكر القداح فإذا نهد فيها قدح ينأوله دفعه إلى الرقيب، فإذا كان مما لا حظ له، رد إلى الربابة فإن خرج بعده المسبل مثلاً أخذ الثلاثة الباقية وغرم الذين خأبوا ثلاثة أنصباء من جزور آخر، وعلى ذلك أبداً يفعل بمن فاز ومن خاب، فربما نحروا عدة جزر، ولا يغرم الذين فازوا من ثمنها شيئاً، وإنما الغرم على الذين خأبوا، وكان عندهم أنه لا يحل للخائبين أن يأكلوا من ذلك اللحم شيئاً؛ فإن فاز قدح الرجل فأرادوا أن يعيدوا قدحه ثانية على خطإ فعلوا ذلك به؛ وقد نظم الصاحب إسماعيل بن عباد أسماء القداح التي لها النصيب فوزاً وغرماً في أبيات فقال:
إن القداح أمرها عجيب ** الفذ والتوأم والرقيبوالحلس ثم النافس المصيب ** والمصفح المشتهر النجيبثم المعلى حظه الرغيب ** هاك فقد جاء بها الترتيبومنها الأزلام: وهي ضرب من الطيرة، كانوا إذا أرادوا فعل أمر ولا يدرون ما الأ مر فيه، أخذوا قداحاً مكتوباً على بعضها افعل، لا تفعل، وعلى بعضها نعم، وعلى بعضها لا، وعلى بعضها خذ، وعلى بعضها سر، وعلى بعضها سريع، فإذا أراد أحدهم سفراً مثلاً أتى سادن الأوثان، فيضرب له بتلك القداح ويقول: اللهم أيها كان خيراً له فأخرجه! فما خرج له عمل به، وإذا شكوا في نسب رجل أجالوا القداح وفي بعضها مكتوب صريح، وفي بعضها مكتوب ملحق؛ فإن خرج الصريح أثبتوا نسبه، وإن خرج الملحق نفوه. وإن كان بين اثنين اختلاف في حق سمى كل منهما له سهماً وأجالوا القداح فمن خرج سهمه فالحق له وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله:
{وأن تستقسموا بالأزلام}.ومنها البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام.فأما البحيرة، فكانت الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن عمدوا إلى الخامس منها ما لم يكن ذكراً فشقوا أذنها وتركوها، فلا يجز لها وبر، ولا يحمل عليها شيء ولا يذكر عليها إن ذكيت اسم الله تعالى، وتكون ألبانها للرجال دون النساء.وأما السائبة فكان الرجل يسيب الشيء من ماله: بهيمة أو عبداً، فيكون حراماً أبداً وتكون منافع ذلك للرجال دون النساء.وأما الوصيلة فكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا إلى السابع فإن كان ذكراً ذبح، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قيل وصلت أخاها فحرما جميعاً، وكانت منافعهما ولبن الأنثى منهما للرجال دون النساء.وأما الحام، فكان الفحل إذا صار من أولاده عشرة أبطن، قالوا حمى ظهره، فيترك، ولا يحمل عليه شيء، ولا يركب، ولا يمنع ماء، ولا مرعى، وقد أخبر الله تعالى ببطلان ذلك بقوله:
{ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام}.ومنها إغلاق الظهر: كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة عمد إلى البعير الذي كملت به مائة فأغلق ظهره بأن ينزع شيئاً من فقراته ويقعر سنامه كي لا يركب ليعلم أن إبل صاحبه قد أمأت.ومنها التفقئة، والتعمية. كان الرجل إذا بلغت إبله ألفاً فقأ عين الفحل: وهي التفقئة، فإن زادت على ذلك فقأ العين الأخرى وهي التعمية، ويزعمون أن ذلك يدفع العين عن الإبل قال الشاعر:
وهبتها وأنت ذو امتنان ** تفقأ فيها أعين البعرانومنها نكاح المقت: وهو نكاح زوجة الأب، وكان من شأنها فيه أن الرجل إذا مات قام أكبر ولده، فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها، فإن لم يكن له فيها حاجة يزوجها بعض إخوته بمهر جديد، فكانوا يتوارثون النكاح كما يرثون المال، فأنزل الله تعالى:
{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً}.وحرم زوجة الأب بقوله:
{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاشحة ومقتاً وساء سبيلاً} ومن ثم سمي نكاح المقت.ومنها رمي البعرة: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها، دخلت حفشاً يعين خصاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمضي عليها سنة، ثم يؤتى بدابة: حمار أو شاة أو طيرن فتفتض به أي تتمسح به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج بعد ذلك فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره فنسخ الإسلام ذلك بقوله تعالى:
{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.ومنها وأد البنات وهو قتلهن. كانوا يقتلونهن خشية العار؛ وممن فعل ذلك قيس بن عاصم المنقري، وكان من وجوه قومه ومن ذوي المال، وكان سبب ذلك أن النعمان بن المنذر أغزاهم جيشاً فسبوا ذراريهم فأناب القوم وسألوه فيهم فقال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه، وكل من اختارت صاحبها تركت معه، فكلهن اخترن آباءهن إلا ابنة لقيس بن عاصم فإنها اختارت صاحبها عمرو بن الجموح، فنذر قيس أنه لا يولد له ابنة إلا قتلها فكان يقتلهن بعد ذلك. وورد القرآن بإعظام ذلك بقوله:
{وإذا المؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت}.ومنها قتل الأولاد خشية الإملاق والفاقة، فكان الرجل منهم يقتل ولده مخافة أن يطعم معه إلى أن نهى الله تعالى عن ذلك بقوله:
{ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأً كبيراً}.ومنها حبس البلايا؛ كانوا إذا مات الرجل يشدون ناقته إلى قبره ويقبلون برأسها إلى ورائها ويغطون رأسها بوليه وهي البرذعة فإذا أفلتت لم ترد عن ماء ولا مرعى، ويزعمون أنهم إذا فعلوا ذلك حشرت معه في المعاد ليركبها قال أبو زبيد:
كالبلايا رؤوسها في الولايا ** مانحات السمو حر الخدودومنها الهاة، كانوا يزعمون أن الإنسان إذا قتل ولم يطالب بثأره، خرج من رأسه طائر يسمى الهامة، وصاح: اسقوني اسقوني حتى يطالب بثأره؛ قال ذو الأصبع:
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي ** أضربك حتى تقول الهامة اسقونيومنها تأخير البكاء على المقتول للأخذ بثأره، كان النساء لا يبكين المقتول منهم حتى يؤخذ بثأره، فإذا أخذ به بكينه حينئذ، قال الشاعر:
من كان مسروراً بمقتل مالك ** فليأت نسوتنا بوجه نهاريجد النساء حواسراً يندبنه ** يلطمن حر الوجه بالأسحارومنها تصفيق الضال: كان الرجل منهم إذا ضل في الفلاة، قلب ثيابه وحبس ناقته وصاح في أذنها كأنه يومئ إلى إنسان وصفق بيديه قائلاً: الوحا الوحا النجاء النجاء هيكل الساعة الساعة، إلي إلي عجل، ثم يحرك ناقته فيزعمون أنها تهتدي إلى الطريق حينئذ. قال الشاعر:
وآذن بالتصفيق من ساء ظنه ** فلم يدر من أي اليدين جوابهايريد إذا ساء ظنه حين يضل.ومنها الغول: كانوا يزعمون أن الغول تتراءى لأحدهم في الفلاة فيتبعها فتستهويه، وربما ادعى أحدهم أنه قابلها وقاتلها قال تأبط شراً:
ألا من مخبر فتيان فهم ** بما لاقيت عند رحا بطانبأني قد لقيت الغول تهوي ** بسهب كالصحيفة صحصحانفقلت لها كلانا نضو أرض ** أخو سفر فخلي لي مكانيفشدت شدة نحوي فأهوت ** لها كفي بمصقول يمانيفأضربها بلا دهش فخرت ** صريعاً لليدين وللجرانومنها ضرب الثور ليشرب البقر: كانوا يزعمون أن الجن تركب الثيران فتصد البقر عن الشرب، فيضربون الثور ليشرب البقر؛ قال الشاعر:
كذاك الثور يضرب بالهرواى ** إذا ما عافت البقر الظماءومنها تعليق سن الثعلب وسن الهرة وحيض السمرة: كانوا يزعمون أن الصبي إذا خيف عليه نظرة أو خطفة فعلق عليه شيء من ذلك، سلم من آفته، وأن الجنية إذا أرادته لم تقدر عليه؛ قالت امرأة تصف ولداً:
كانت عليه سنة ن هرة ** وثعلب والحيض حيض السمرةومنها تعليق كعب الأرنب: كانوا يعلقونه على أنفسهم، ويزعمون أنه وقاية من العين والسحر، قائلين إن الجن تنفر من الأرنب لكونها تحيض قال الشاعر:
ولا ينفع التعشير إن حم واقع ** ولا ودع يغني ولا كعب أرنبومنها تعليق الحلي على السليم وهو الملسوع: كانوا إذا لسع فيهم إنسان علقوا عليه الحلي من الأساور وغيرها، ويتركونه سبعة أيام ويمنع من النوم فيفيق، قال النابغة:
يسهد من وقت العشاء سليمها ** لحلي النساء في يديه قعاقعومنها وطء المقاليت القتلى: كانوا يزعمون أن المرأة المقلات وهي التي لا يعيش لها ولد إذا وطئت قتيلاً شريفاً بقي أولادها، قال بشر بن أبي خازم:
يظل مقاليت النساء يطأنه ** يقلن ألا يلقى على المرء مئزرومنها مسح الطارف عين المطروف: كانوا يزعمون أن الرجل إذا طرف عين صاحبه فهاجت فمسح الطارف عين المطروف سبع مرات يقول في كل مرة: بإحدى جاءت من المدينة، باثنتين جاءتا من المدينة، بثلاث حئن من المدينة إلى سبع سكن هيجانها.ومنها كي السليم من الإبل ليبرأ الجرب منها: كانوا يزعمون أن الإبل إذا أصابها عر وهو الجرب فكووا صحيحاً إلى جانبه ليشم رائحته بريء، وربما زعموا أنه يؤمن معه العدوى، قال النابغة:
وكلفتني ذنب امرئ وتركته ** كذي العر يكوى غيره وهو راتعومنها ذهاب الخدر من الرجل: كانوا يقولون إن الرجل إذا خدرت رجله فذكر أحب الناس إليه ذهب عنه الخدر، قالت امرأة من كلاب:
إذا خدرت رجلي ذكرت ابن مصعب ** فإن قلت عبد الله أجلى فتورهاومنها الحلى عن الصبيان بجباية الحي وإطعامه الكلاب: كانوا يرون أن الفتى إذا ظهر فيبه الحلى بشفته وهي بثور تنبت بالشفة فيأخذ منخلاً على رأسه ويمر بين بيوت الحي وينادي: الحلى الحلى فيلقى في منخله من هنا تمرة، ومن هناك كسرة، ومن هنا قطعة لحم فإذا امتلأة نثره بين الكلاب فيذهب عنه الحلى.ومنها شق الرداء والبرقع، لدوام الحبة: زعموا أن المرأة إذا أحبت رجلاً أو أحبها ولم تشق عليه رداءه ويشق عليها برقعها فسد حبهما قال الشاعر:
إذا اشق برد شق بالبرد برقع ** دواليك حتى كلنا غير لابسفكم قد شققنا من رداء محبر ** ومن برقع عن طفلة غير عانسومنها رمي سن الصبي المثغر في الشمس: يقولون: إن الغلام إذا أثغر فرمى سنه في عين الشمس بسبابته وإبهامه وقال أبدليني بها أحسن منها، أمن على أسنانه العوج والفج والنغل قال طرفة:
بدلته الشمس من منبته ** برداً أبيض مصقول الأشرومنها التعشير: زعموا أن الرجل إذا أراد دخول قرية فخاف وباءها فوقف على بابها قبل أن يدخلها فعشر كما ينهق الحمار ثم دخلها، لم يصبه وباؤها قال عروة بن الورد:
لعمري لئن عشرت من خشية الردى ** نهاق حمير إنني لجزوعومنها عقد الرتم: وهو نبت معروف كان الرجل إذا أراد سفراً عمد إلى رتم فعقده فإن رجع ورآه معقوداً، اعتقد أن امرأته لم تخنه، وإن رآه محلولاً اعتقد أنها خانته، قال الشاعر:
خانته لما رأت شيباً بمفرقه ** وغره جلفها والعقد للرتمومنها اعتبار دائرة المهقوع: وهي دائرة تكون في عنق الفرس يقال لها الهقعة على ما يأتي ذكره في الكلام على الخيل في الطرف الآتي، كانوا يزعمون أن الفرس المهقوع إذا عرق تحت صاحبه اغتلمت حليلته، وطلبت الرجال، قال الشاعر:
إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت ** حليلته وازداد حراً عجانهاومنها خضاب نحر الفرس السابق: كان من عادتهم إذا أرسلوا خيلاً على صيد فسبق أحدها خضبوا صدره بدم الصيد علامة له، قال الشاعر:
كأن دماء العاويات بنحره ** عصارة حناء بشيب مرجلومنها جز ناصية الأسير: كانوا إذا أسروا رجلاً ثم منوا عليه فأطلقوه، جزوا ناصيته ووضعوها في كنانة، قالت الخنساء:
جزرنا نواصي فرسانهم ** وكانوا يظنون أن لا تجزا